للقرآن روعة تهتز لها النفوس، ووقْعٌ تخشع له القلوب، وقد عبَّر سبحانه عن هذا الوقع، وتلك الروعة، فقال: { الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم } (الزمر:23)، بل إن الجماد نفسه ليتأثر بروعة هذا القرآن، { لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله } (الحشر:21)، حتى إن الجن لما استمعت لهذا القرآن عجبت لأمره، وقالت: { إنا سمعنا قرآنا عجبا } (الجن:1) .
وكان
مشركو العرب أهل بلاغة وفصاحة، استشعروا عظمة القرآن في نفوسهم، وعرفوا
أثره في قلوبهم، غير أن كبرهم منعهم من الإيمان به، وعنادهم صدهم عن
الاستسلام له، حتى قالوا { للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين } (سبأ:43) .
وقد
استطاع الوليد بن المغيرة يوم سماعه القرآن، أن يصف بدقة بالغة أثره في
النفوس، حيث قال: ( والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق،
وإن أعلاه لمثمر، وما هو بكلام بشر ) .
وكان
أشد الناس إعراضاً عن هدي السماء، لا ينجو من تأثير القرآن في نفسه، فهذا
عمر رضي الله عنه لما سمع القرآن قبل أن يُسلم، انخلع قلبه من الكفر والشرك
وأقرَّ بالإسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًّا ورسولاً؛ وهذا
أبو ذر رضي الله عنه لما سمع القرآن آمن بما فيه، واستسلم لنور الهداية،
بعد إعراض ونفور .
وكل
منصف للحقيقة يُقرُّ أن الأسلوب الذي جاء عليه القرآن الكريم، والنسق الذي
صيغت عليه آياته، أمر في غاية الروعة والبيان، ولا عجب في ذلك، فهو كلام
رب العالمين، وهو { أحسن الحديث } (الزمر:23)، { ومن أصدق من الله حديثا } (النساء:87) .
وقد
تحدث العلماء قديماً وحديثاً عن الأسباب التي جعلت من القرآن يؤثر هذا
التأثير بسامعيه وقارئيه، فأرجع بعضهم ذلك إلى جانب التعبير اللفظي، وأسلوب
الصياغة، والتناسب الصوتي؛ وأرجعها آخرون إلى جانب النظم، وأحوال
التراكيب، كالتقديم والتأخير، والحذف والذكر، وتفصيل العبارة بحسب مقتضاها؛
وأرجعها فريق ثالث إلى جوانب أخرى بالإضافة إلى هذين الجانبين .
وكان
من أنصار الاتجاه الأول الجاحظ والرماني، وكان من أنصار الاتجاه الثاني
عبد القاهر الجرجاني، صاحب كتاب "دلائل الأعجاز" الذي ضمنه ما يسمى بـ
(نظرية النَّظم) .
وقد
أولى المعاصرون من المهتمين بالدراسات القرآنية هذا الجانب عناية خاصة،
وأبرزوا تلك الخصائص الجمالية التي تضمنها القرآن، سواء في جانب اللفظ
والعبارة، أم في جوانب النظم والتركيب، أم في جانب الصوت والإيقاع .
فـ الزرقاني وهو
يتحدث عن خصائص النظم القرآني، ويجعل في مقدمتها ما سماه (مسحة القرآن
اللفظية)، يقول: " إنها مسحة خلابة عجيبة، تتجلى في نظامه الصوتي، وجماله
اللغوي " .
ويقول سيد قطب في
"ظلاله": " إن في هذا القرآن سراً خاصاً، يشعر به كل من يواجه نصوصه
ابتداء، قبل أن يبحث عن مواضع الإعجاز فيها. إنه يشعر بسلطان خاص في عبارات
هذا القرآن. يشعر أن هنالك شيئاً ما وراء المعاني التي يدركها العقل من
التعبير. وأن هنالك عنصراً ما ينسكب في الحس بمجرد الاستماع لهذا القرآن.
يدركه بعض الناس واضحاً، ويدركه بعض الناس غامضاً، ولكنه على كل حال موجود.
هذا العنصر الذي ينسكب في الحس، يصعب تحديد مصدره: أهو العبارة ذاتها ؟
أهو المعنى الكامن فيها ؟ أهو الصور والظلال التي تشعها ؟ أهو الإيقاع
القرآني الخاص المتميز من إيقاع سائر القول المصوغ من اللغة ؟ أهي هذه
العناصر كلها مجتمعة ؟ أم إنها هي وشيء آخر وراءها غير محدود ؟!" .
ولا
شك، فإن روعة القرآن وتفرده تأتي من هذه الأمور مجتمعة، ولا يمكن إرجاع
روعته وتفرده إلى جانب واحد من تلك الجوانب المشار إليها، غير أن الجانب
اللفظي واللغوي من القرآن كان له نصيب لا يستهان به في روعة هذا القرآن
وفرادته؛ ذلك أن القرآن نزل على أمة تقيم وزناً للكلمة، وتهتم بشأن اللغة
بياناً وأسلوباً غاية الاهتمام، وأي شيء في تاريخ الأمم - كما يقول الرافعي - أعجب من نشأة لغوية، تنتهي بمعجزة لغوية .
وإذا
تبين أهمية الجانب اللفظي في إظهار روعة القرآن على وجه الإجمال، نتقدم
خطوة أخرى لنقف بشيء من التفصيل على ظاهرة (التناسب اللفظي) في القرآن،
فنعرفه بداية، ونذكر أنواعه، ونمثل له أمثلة توضح المقصود منه، فنقول:
لم نقف على تعريف محدد لمصطلح (التناسب)، وأقرب ما وقفنا عليه ما ذكره الشيخ الشنقيطي صاحب
"أضواء البيان"، حيث قال: " مراعاة النظير، ويسمى التناسب
والائتلاف...وضابطه: أنه جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد "، وحاصل ما ذكره الشنقيطي : أن التناسب هو التوافق والانسجام بين مجموعة من الألفاظ، بحيث يكون كل لفظ منها موافقاً لغيره، من غير تنافر، ولا تضاد .
والتعبير
الدارج عند البلاغين والمفسرين عن مصطلح (التناسب) هو مصطلح (المشاكلة)؛
و(المشاكلة) أصل من أصول العربية، تُطْلَب في الكلام، ويُترك لأجلها ما
يقتضيه الميزان الصرفي أو القاعدة الإعرابية، ويقصدها الفصحاء والبلاغيون؛
لما لها من قيمة جمالية .
وقد أكد أهل العربية هذا الأصل، فقالوا: " قد تحدث أشياء توجب تقديم غير الأصل على الأصل للتشاكل، وهو ما يوجب الموافقة " .
ومن الأمثلة التي يذكرونها على (التناسب)، قوله تعالى: { أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده } (العنكبوت:19)، قالوا: إن الفصيح في (بدأ يبدأ) الثلاثي، ولم يُسمع (أبدأ) الرباعي، لكن فَصُح استعمال الرباعي في الآية { يبدئ } مضارع (أبدأ)؛ لمناسبته لقوله تعالى: { يعيده }، إذ هو من (أعاد) الرباعي .
ثم إن التناسب على أنواع:
فهناك تناسب الجزاء،
وهذا النوع من التناسب يكثر وقوعه في الآيات التي تضمنت الإشارة إلى جزاء
الله على الأفعال السيئة؛ كالاستهزاء، والخداع، والمكر، والنسيان، ونمثل
لكل منها بمثال:
فمن أمثلة الاستهزاء قوله تعالى: { وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون * الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون }
(البقرة:14-15)، فقد صرحت الآية باستهزاء الله سبحانه بهؤلاء المنافقين،
الأمر الذي قد يستشكله البعض، ويقول: كيف يكون استهزاء منه سبحانه؟ يجيب عن
هذا التساؤل القرطبي قائلاً: " وإنما قاله
ليزدوج الكلام، فيكون أخف على اللسان من المخالفة بينهما. وكانت العرب إذا
وضعوا لفظاً بإزاء لفظ جواباً له وجزاء، ذكروه بمثل لفظه، وإن كان مخالفاً
له في معناه، وعلى ذلك جاء القرآن والسنة ". وقال الشوكاني : " فلا يسند إلى الله سبحانه إلا على طريق المشاكلة ". وقال ابن عاشور :
هذا " تمثيل لمعاملة الله إياهم في مقابلة استهزائهم بالمؤمنين، بما يشبه
فعل المستهزئ بهم، وذلك بالإملاء لهم حتى يظنوا أنهم سلموا من المؤاخذة على
استهزائهم، فيظنوا أن الله راض عنهم"، إلى أن قال: "ويُحِّسن هذا التمثيل
ما فيه من المشاكلة" .
وقال تعالى: { يخادعون الله وهو خادعهم }
(النساء:142)، ويثار هنا من السؤال ما أثير في الآية السابقة؛ إذ لا شك أن
الخداع من صفات البشر، ولا يليق أن يوصف به الخالق سبحانه، وإذا كان الأمر
كذلك، كان معنى { وهو خادعهم }، كما قال أبو حيان : " أي: منـزل الخداع بهم، وهذه عبارة عن عقوبة سماها باسم الذنب". وقال ابن عاشور :
" إسناد خادع إلى ضمير الجلالة إسناد مجازي اقتضته المشاكلة...فالمشاكلة
ترجع إلى التمليح، أي: إذا لم تكن لإطلاق اللفظ على المعنى المراد علاقة
بين معنى اللفظ والمعنى المراد إلا محاكاة اللفظ، سميت مشاكلة كقول جحظة البرمكي :
قالوا: اقترح لوناً يُجاد طبيخه قلت: اطبخوا لي جُبَّة وقميصاً "
فاستعمل الشاعر الفعل (اطبخوا)، مع أن الجبة والقميص تخاط خياطة؛ ليناسب قوله أولاً: (طبيخه) .
وقوله تعالى: { ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين } (آل عمران:54)، قال أبو حيان :
" (ومكر الله): مجازاتهم على مكرهم، سمى ذلك مكراً؛ لأن المجازاة لهم
ناشئة عن المكر…وكثيراً ما تسمى العقوبة باسم الذنب، وإن لم تكن في معناه" .
وقوله تعالى: { نسوا الله فنسيهم } (التوبة:67)، قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: (يتركهم في العذاب كما تركوا النظر للقاء هذا اليوم)، قال أبو حيان : " وإن قُدِّر النسيان بمعنى الذهول من الكفرة، فهو في جهة الله تسمية العقوبة باسم الذنب " .
ومما هو من قبيل تناسب الجزاء غير ما تقدم، قوله تعالى: { وإن تعودوا نعد } (الأنفال:19)، وقوله سبحانه: { إنهم يكيدون كيدا * وأكيد كيدا } (الطارق:15-16)، وقوله تعالى: { فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم } (الصف:5)، وقوله سبحانه: { ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم } (التوبة:127) .
قال الطبري في
بيان هذا النوع من التناسب - تناسب الجزاء -: أخرج خبره عن جزائه إياهم
وعقابه لهم، مخرج خبره عن فعلهم الذي عليه استحقوا العقاب في اللفظ، وإن
اختلف المعنيان، كما قال جل ثناؤه: { وجزاء سيئة سيئة مثلها }
(الشورى:40)، ومعلوم أن الأولى من صاحبها سيئة؛ إذ كانت منه لله معصية،
وأن الأخرى عدل؛ لأنها من الله جزاء للعاصي على معصيتة، فهما وإن اتفقتا من
جهة اللفظ، إلا أنهما اختلفتا من جهة المعنى. وكذلك قوله: { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه } (البقرة:194)، فالعدوان الأول ظلم، والثاني جزاء لا ظلم، بل هو عدل؛ لأنه عقوبة للظالم على ظلمه، وإن وافق لفظه لفظ الأول .
ومن أنواع التناسب تناسب الجنس،
وهو كثير في القرآن الكريم، والمراد من هذا النوع: استعمال لفظين، يجمعهما
أصل واحد في اللغة، للدلالة على معنيين، ويسمى عند البلاغيين (الجناس) .
وتناسب الجنس، إما أن يكون تناسباً بين اسم وفعل، كقوله تعالى: { يمحق الله الربا ويربي الصدقات } (البقرة:276)، فالتناسب اللفظي هنا وقع بين كلمتين من أصل واحد، إحداهما: فعل، وذلك قوله تعالى: { ويربي } والثانية: اسم، وذلك قوله تعالى: { الربا }. ومثل ذلك يقال في قوله سبحانه: { ولا تزر وازرة وزر أخرى } (الأنعام:146)، فالتناسب اللفظي هنا وقع بين قوله: { تزر }، وقوله: { وازرة }.
والأغلب في هذا النوع من التناسب أن يتقدم الفعل على الاسم، كما في
الآيتين السابقتين، والأقل أن يتقدم الاسم على الفعل، كما في قوله تعالى: { فطرة الله التي فطر الناس عليها } (الروم:30) .
وإما أن يكون تناسب الجنس تناسباً بين فعلين، كقوله تعالى: { وللبسنا عليهم ما يلبسون } (الأنعام:9)، وقوله سبحانه: { فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم } (الصف:5) .
وإما أن يكون التناسب بين اسمين، كقوله تعالى: { والقناطير المقنطرة } (آل عمران:14)، وقوله سبحانه: { أفمن يهدي إلى الحق أحق } (يونس:35) .
وهذا النوع من التناسب اللفظي فيه من الحلاوة والعذوبة وله من الوقع في نفس القارئ ما لا يخفى .
ومن أنواع التناسب اللفظي التناسب الصوتي،
وهذا النوع من التناسب يكون بين كلمتين لا يجمعهما أصل لغوي واحد، وإنما
الذي يجمع بينهما تجانس الصوت، الذي يحسن في أذن المستمع، من أمثلة هذا
النوع قوله تعالى: { قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها } (البقرة:144)، فثمة تناسب صوتي بين كلمة { تقلب } وكلمة { قبلة }، ولهما وقع في أذن السامع؛ ومنه أيضاً قوله سبحانه: { يؤذون النبي ويقولون هو أذن } (التوبة:61)، فبين قوله سبحانه: { يؤذون } وقوله: { أذن } تناسب لفظي لمن تفطن له. ومن هذا القبيل قوله سبحانه: { ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون } (غافر:75)، وقوله تعالى: { وهم ينهون عنه وينأون عنه } (الأنعام:26)، وقوله عز وجل: { وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا } (الكهف:104) .
ومن أنواع التناسب اللفظي المناسبة بين مطلع الآية وخاتمتها، وتظهر أهمية هذا النوع من المناسبة من جهة رد آخر الكلام على أوله، وهذا ما يسمى في الشعر بـ (رد العجز على الصدر) .
ومن أمثلة هذا النوع قوله تعالى: { فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين } (المائدة:42)، فقد خُتمت الآية بلفظ (القسط) كما بُدأت به؛ ومنه قوله سبحانه: { ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين } (البقرة:190)، فبدأت الآية بلفظ (الاعتداء) وخُتمت به. ومن هذا القبيل قوله سبحانه: { وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا } (النساء:81)، وقوله تعالى: { ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين } (الأعراف:89) ونحو ذلك كثير .
ويشار
هنا إلى أن هذا النوع من التناسب قد يقع أيضاً بين آية وأخرى، أو بين
بداية السورة ونهايتها، وتفصيل القول فيه ليس هذا مكانه .
ومن أنواع التناسب اللفظي التصوير البياني،
ومعناه أن تكون هناك وحدة بين أجزاء الصورة البيانية، فلا تتنافر
جزئياتها، بل تكون متآلفة غاية الائتلاف، ومنسجمة نهاية الانسجام .
ومن أمثلة هذا النوع من التناسب، قوله تعالى: { هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور } (الملك:15)، فقوله سبحانه: { ذلولا }
تصوير للأرض التي تسبح في الفضاء، والإنسان راكب على ظهرها، في صورة حيوان
مركوب، مطيع لراكبه، خاضع لإرادته وحاجته. وقوله تعالى: { فامشوا في مناكبها }
تعبير مناسب لهذه الصورة، و(المنكب): مجتمع رأس الكتف والعضد، والمراد:
فامشوا في أنحائها، ولو قيل: (فامشوا في أنحائها) لما كان مناسباً، ولفاتت
وحدة الصورة، وبعُد تناسب أجزائها .
وعلى هذا النحو قوله سبحانه: { بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون * ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض }
(المؤمنون:70-71)، على رأي من قال من المفسرين: إن الحق هو الله، فتكون
الآية واردة على أسلوب المشاكلة، الذي يحفظ وحدة نسق العبارة، ويزيد من
جمالها ووقعها .
وكذلك قوله تعالى: { لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير * قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه }
(الأنعام:103-104)، فالمراد من الآية أن الله سبحانه يدرك الأشياء كلها،
دقَّها وجلَّها، واللفظ القرآني يؤدي هذا المعنى بطريقة جمعت بين وضوح
الدلالة، وجمال العبارة، ومرجع ذلك تلك المشاكلة اللفظية .
ولا بأس من الإشارة هنا إلى أن المفسرين قد اعتنوا بجانب التناسب اللفظي، كل منهم بقدر، وأكثر من نبه عليه من المتقدمين القرطبي و أبو حيان الأندلسي ، ومن المتأخرين الآلوسي و ابن عاشور .
أخيراً،
فإن التناسب اللفظي في القرآن لا يطلب لذاته بل لما ورائه من معنى؛ إذ هو
الأساس والمقصود، والميزة التي انفرد بها القرآن، أنه استعمل هذه الأنواع
التعبيرية، لإيصال المعاني المطلوبة، فجمع بين الوفاء بحق اللفظ والمعنى
على حد سواء .
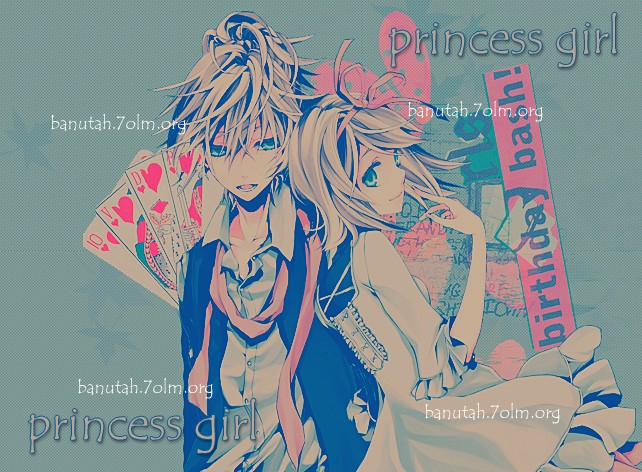
 اهلا وسهلا بكـ , لديك: 0 مشاركة.
اهلا وسهلا بكـ , لديك: 0 مشاركة. آخر زيارة لك في : الخميس يناير 01, 1970 .
آخر زيارة لك في : الخميس يناير 01, 1970 . 